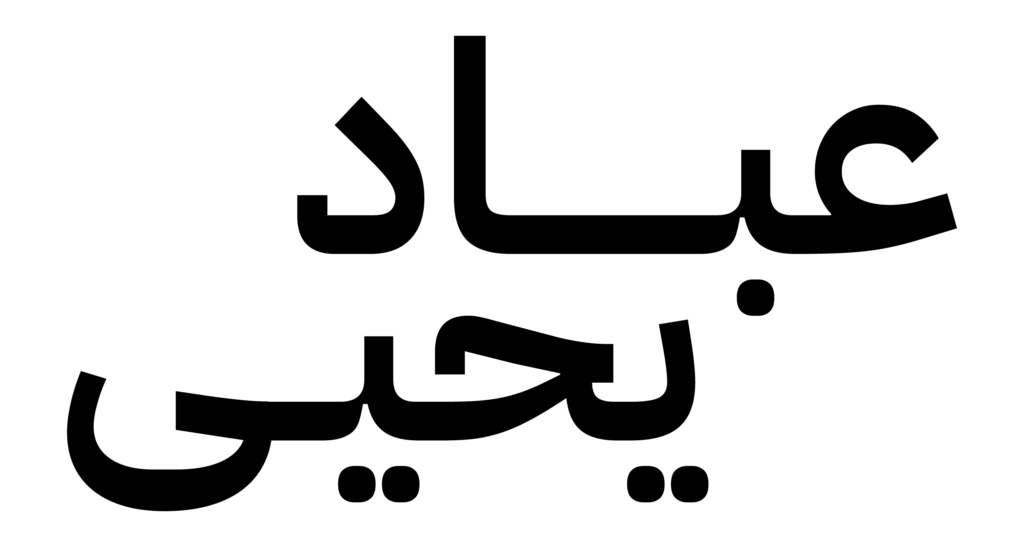رام الله، تاريخ مدينة عبر حكاية عائلة النجار ودارهم والتي من خلالها نكتشف المدينة ومختلف التحولات والتغيرات التي طرأت عليها بعبور الأزمنة المتلاحقة والمتعاقبة عليها، بدءا من الحكم العثماني ثم الانتداب البريطاني، وصولا إلى ما آلت إليه السلطة الفلسطينية الماضية والحاضرة، مرورا بالحروب العالمية الأولى والثانية والنكبة؛ ثم الانتفاضات الفلسطينية وما تشكّل بعدها.
عباد يحيى كاتب وباحث فلسطيني، حصل على الماجستير في علم الاجتماع من جامعة بيرزيت، عمل صحافيا في وسائل إعلام عربية وفلسطينية عديدة. سبق وصدرت له «القسم 14»، و«هاتف عمومي» كما كتب أيضا روايتين تدور أحداثهما في رام الله: «رام الله الشقراء» و«جريمة في رام الله» قبل أن ينفرد بالعنوان والموضوع كله للمكان ويفسح له المجال للتعبير والبوح عن كل ما فيه، كأن هذه المدينة تسكنه لا هو يسكن فيها.
تنقلنا الرواية عبر صفحاتها إلى تاريخ المدينة، الماضي والحاضر، عبر زمنين وحكايتين متداخلتين، عبر فصولها أو عتباتها كما أراد الكاتب عنونتها. ستغوص في الرمزية التي اعتمدها الكاتب كثيرا، ما منح الرواية عمقا وأهمية، حيث تجعلك في حالة تدبر معانيها وكناياتها. إضافة إلى اللغة التي اعتمدها عباد يحيى لسرد حكاية مدينته، قوتها وشاعريتها، مستعيدا الحنين الأول للغة الضاد وهنا قوة الرواية وعتبتها الأساسية، وهي المميزة التي تجعل القارئ ينغمس فيها غير آبه لحجمها فجمال اللغة وعمق المعاني ستدفعك في نهايتها لطلب المزيد من الصفحات. فعلى سبيل المثال لا الحصر، نجد أن الكاتب استعمل لفظي «البيت» و«الدار»، فالأول للدلالة على الحيز المكاني الصغير والثابت الذي يحتله أفراد العائلة، بحيث يرتاحون فيه ويمارسون أنشطتهم اليومية كما غنت صباح «يا بيتي، يا بويتاتي» من كلمات مارون كرم ولحنها الكبير وديع الصافي. فالبيت هنا دلالة على الرقعة الجغرافية الصغيرة المحددة الأركان، أما الثاني – لفظ الدار- فوظفه ليدل على مفهوم أشمل و يشار بها إلى الوطن والبناء الأكبر والأوسع بخلاف البيت الذي يشار فيه إلى الفضاء الذي يشغله الساكن، كقوله تعالى في سورة الحشر (وَالَّذِينَ تَبَوَّءُو الدَّارَ وَالْإِيمَنَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ …) الآية 9، وما أحسن من كتاب الله استشهادا بعمق المعنى وقوة الكلمة.
رواية أبدع فيها الكاتب، عبر بنائه الروائي المتين والمتراص بحيث تتبع تاريخ رام الله من خلال تعقب أسرة بطرس النجار لفترات طويلة من الزمن؛ وهذا ما يحيلني إلى القول، وما خطر ببالي وأنا أقرأ الرواية وأقتفي سير أحداثها، إن هذه الرواية تذكرني برائعة ماركيز «مئة عام من العزلة» التي سافرنا من خلالها إلى الساحرة ماكوندو من خلال تتبع عائلة بوينديا على مدى أجيال متلاحقة، الفرق بين ماكوندو ماركيز ورام الله عباد يحيى، أن الأولى متخيلة والثانية واقعية بكل تفاصيلها، فهنا يتقاطع المتخيل والواقع لينتجا ابداعا عجائبيا لا مثيل له. فتواصل الخط الزمني لفترات طويلة كسلسلة محكمة العقد، ينتج تداخلا بين الحديث والقديم وما تخللهما من متغيرات شكلت الهيكل العام لرام الله التي تعرفنا إليها الرواية بأدق تفاصيلها دون الحاجة لجواز سفر للعبور والاستكشاف.
سيتضح جليا للقارئ تطور المدينة، من خلال تطور عمرانها والمتمثل في بيت النجار حيث أسس على غرفتين حتى وصل به الحال مركزا لاجتماعات نافذين في السلطة الفلسطينية، وفي كل زيادة للبيت تستقبلك العتبة الجديدة مرحبة وممهدة لأحداثها وتطورات ما بعدها مفصلة فصلا من فصول تاريخ فلسطين. وهنا استحضر ما جاء على لسان ثالث العتبات: «أنا عتبة الخوف من الحرب وعتبة الحرب، عتبة الرجاء والخشية. عتبة عاد بها بطرس إلى الخلف ليحتمي من القادم؛ فوجدها تلقي به إلى قادم لم يتخيله. أنا عتبة النهاية لمُلك، حمل في زفيره الأخير ملامح المُلْك الآتي». وتودعك برسم تخطيطي لزيادات الدار، وأيضا عبر تاريخ العائلة وتطورها عبر الزمن، حيث استقرت في القرية من خلال جد بطرس، «الذي لم يعرف أهل القرية اسما له ولكنهم أحبوا ذلك الغريب الذي أتاهم خاوي اليدين إلا من حرفة هم بحاجة إليها، فاستقر فيها بعد سنوات التشريد الطويلة، عاش بين أهل رام الله دهرا لا يطلب شيئا إلا العمل ومقابله»، لكنه تزوج منها فاختلط بهم بالنسب، نذروا أعمارهم وزيجاتهم لدرب رام الله الطويل، فالزواج يلد مصيرا واضحا ربما يعقبه يقين.
فكان له ولد بكر سموه إبراهيم ما جعل أهل القرية يتنبؤون له بذرية وافرة وهو ما كان فعلا، إلا أنها وفرة في الإناث، فعدا بكره إبراهيم لم ينجب أي ولد، جاء بطرس إلى الدنيا بعد وفاة جده بسنة كاملة ولم تنجب أمه بعده. اقتصرت عائلة النجار على رجلين، إبراهيم وبطرس الذي رزق بسبع بنات، بكره نعمة وآخر عنقوده خليل.
يبقى للمكان هالته وللأشخاص سحرهم وبصمتهم عليه، ستبقى رام الله عالقة في وجداننا وشخوصها متربعة في ذاكرتنا طويلا. نعمة وحكايتها، تلك المظلومة المقهورة حتى آخر أيامها، أكثر الشخصيات العالقة في ذهني وأظنني لن أتمكن من نسيانها. بطرس النجار وقراره تجاه ابنته نعمة، الذي كان مفصليا وحدثا فاصلا لحياة العائلة وتاريخها الآتي. سالم وماري، الحب الذي نثرته رياح التغيير وفرقته خطوة، تلك الخطوة التي انتظرها كل منهما من الآخر، فرقهما تزامنها في الوقت نفسه، أخذ كل منهما خطوته؛ فلم يلتقيا.
خليل، شكلته حملات التبشير عبر مدرسة الفريندز وصاغته المتغيرات ودفعته للاغتراب، الاندماج في المجتمع الأمريكي المتشعب الأعراق.
حنة، فرحة، جميل، سعاد، افلين وجهاد؛ من الوافدين إلى بيت النجار، مقيمين ومؤنسين وحدة هيلانة أو عابرين، «حيث دخل الدار كثيرون، ساكنوها دخلوها كما يدخل صاحب بيت، والضيوف طرقوا الأبواب أو ندهوا على أصحاب الدار ليفتحوا لهم. آخرون اختلسوا دخولا بتواطؤ مع أحد ساكنيها، ودخلها من احتال على أحد ساكنيها. دخل البيت لصوص وعمال وصنايعية، دخول بالرضا وبالعلن وبالسر والغضب والقهر. اقتحمه جنود من أربع دول. دخله سعداء خرجوا حزانى، ودخله خائبون وآبوا بأمل عميم. أقام في الدار راغبون أقل مما اشتهوا، وانتظر فيها كارهون أكثر مما احتملوا. وعرفت عابري سبيل لم يتركوا شيئا فيها ولم يعلق منهم فيها شيء. واحد فقط كسر الشباك ودخل متسللا، وأقام لأمد لم يره طويلا ولا قصيرا ولم يدر أأحبه أم كرهه». مشكلين جميعهم سواء بحضورهم الطاغي أو عبورهم العابر، تاريخ الأرض ومصيرها المحتوم، الماضي وجسر العبور للحاضر.
ريما تلك الناشطة، في منظمة من أجل ضحايا التعذيب ومع توقف التمويل، قررت مع زوجها أن يؤسسا مؤسسة خاصة لرعاية ضحايا التعذيب وتستفيد بذلك من خبرتها في المجال، غسان ذلك المصور الشغوف بالوجوه والأمكنة مشكلا بصوره أرشيف فلسطين الممتد عبر الأزمنة كلها ما جعله الشاهد على أحداثها فكل صورة تحمله إلى يوم التقاطها، صنفها كمراحل وفي كل مرحلة. صوره بمثابة عنوان للحقبة كلها فهو حاوي حكايا المظلومين والمقهورين عبر فلاشاته الفوتوغرافية مجسدا بذلك تاريخ فلسطين المصور والعصي على النكران والبعيد عن كل زيف وتحريف مثلما قال له مدير الوكالة: «تأريخ بصري لا مثيل له لآخر 25 سنة من حياة الفلسطينيين، سياسيا و اجتماعيا وثقافيا..
عماد العايش، الأستاذ الجامعي محرك الرواية ووقودها، يهزه موت زوجته المفاجئ ما سبب له مشاكل نفسية فيجد نفسه في دوامة حزن وأسير فكرة قديمة قالتها جدته، تعود وتسيطر على تفكيره فينطلق باحثا عن جواب لسؤال حياته الأهم، وهل هو فعلا مستعد لسماع واكتشاف كل شيء؟
ريما غسان وعماد الخيط الذي يربط بين الماضي والحاضر مشكلين بذلك الزمن الحالي وتاريخ المدينة الراهن.
أما رام الله فما بقي من الحلم عند الصحو، وستبقى تحت رحمة قوى تاريخية خارج نطاق سيطرتها، وفهمها وإدراكها، فقد دخلها أبو عمار لتكون مركزا للسلطة الفلسطينية، فهل كانت فعلا اختيارا إراديا أم مفروضا؟ فمسار اللجوء والنضال، الثورة والخسارة تضع بيروت أمام المشهد كله فهي حاضرة في القلب، مركز ما بدأ في فلسطين، وأراد فلسطينيو المنظمة انهاءه بأية طريقة. «البيوت القرميدية المكعبة، نمط العمارة، المزيج المسيحي المسلم، روابط قديمة بين أجداد هنا وأجداد هناك، رائحة البحر البعيد، رؤيته من الإرسال وبطن الهوا والطيرة في أيام صفو، ربما أيضا الفريندز وجامعة بيرزيت».
فالمكان له دلالته الرمزية بمعان ذاتية تعبر عن أحاسيس الحب، الوفاء والولاء للأرض بوصفه جزءا من الهوية. «علمت العتبات الدكتور عماد أن ينظر في رام الله كأنه يحدق في وجه شيخ أو عجوز، طبقات البناء وتعدده واختلافه، تجاعيد في وجه رام الله، تقول الكثير عن الزمن الطويل وكيف مر. من تجاعيد وجه عجوز يمكنك تخيل أي حياة عاشها، انحناءات غضب، تغضنات صبر، منعرجات سعادة، التواءات رضا، مسارات رغبة»، ويختم عباد يحيى روايته بقائمة للمراجع، كتب، دراسات، مقالات، مذكرات وروايات تناولت تاريخ رام الله وحتى الصحف والمجلات.
تقول الرواية: «إن ما يؤخر هذه البلاد عن حاضر العالم، مرضها بالحنين كلما دخلت في عصر حنت إلى سابقه، ستظل هذه البلاد أبطأ ما ظل فيها الحنين، وسيظل دوما في دخيلة كل رجل وامرأة وفي عاطفة الناس كلهم. إن الحنين إلى الماضي، يؤخر مضيه والخوف من المستقبل يؤخر حلوله».
سأختم بقول العظيم ماركيز: «ليست الذكرى الأكثر ديمومة وحيوية عندي هي ذكرى الناس، بل هي ذكرى البيت الحقيقي في أراكاتاكا الذي عشت فيه مع جدتي»، فالمكان له الحضور الطاغي في المبدع المسكون بهويته، والمناضل من أجل حقها المسلوب.
راضية ريش
عباد يحيى: «رام الله»
منشورات المتوسط، ميلانو، 2020
736 صفحة.