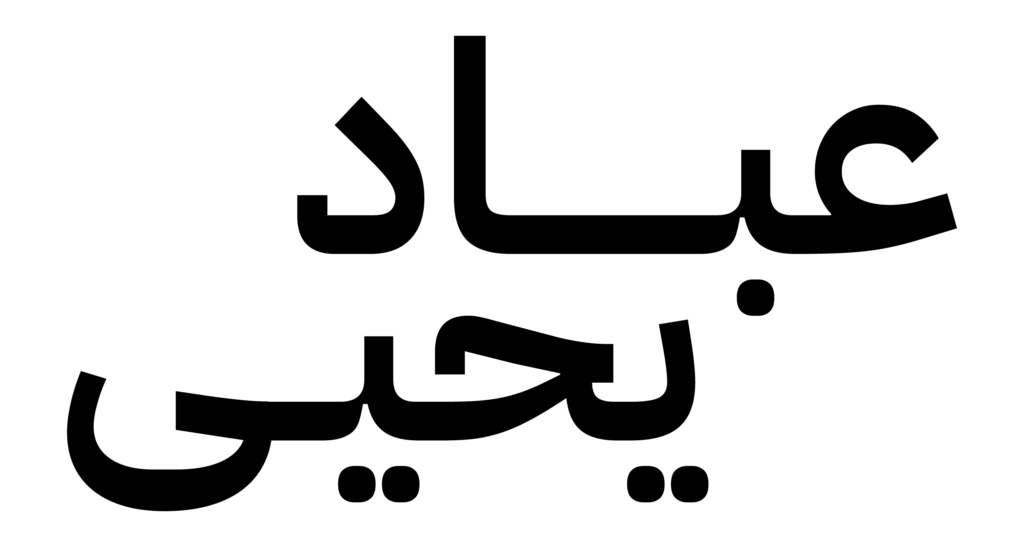كتبت بديعة زيدان:
ما إن انتهيت من قراءة رواية “رام الله” لعبّاد يحيى، حتى خرجت في جولة بالمدينة، أتأمل منازلها العتيقة في بلدتها القديمة، وصولاً إلى مقر بلديّتها، حيث نصب راشد الحدّادين وأسرته المعدني في ساحة المبنى .. حدّقت في ملامحهم، وبحثت عن أكبرهم الذي هو “صبرة”، والذي حفيده المفترض هو الشخصية المحوريّة في الرواية، أي “بطرس النجار”، الذي قَدِم جدّه، بعد قرن أو يزيد من مغادرة راشد الحدادين إلى الكرك مسقط رأسه ومدينته الأم، دون أن يعرف أنه بين أقاربه، ودون أن يعرفوا أنه ابن دمهم، وأحد أحفاد المؤسس.
“لم يعرف الشاب النجار، ولم يعرف أهله الذين اختفوا من صفحة حياتهم مع أخويه قبل سنين، أنه التحق بأجداده وأهله، من هاجروا قبل قرنين من بادية الأردن عبر البحر الميّت، هرباً من دم محتّم ومعمّد بالخوف على الأهل والرعية، وانتهوا إلى رام الله.. بدا كأنه تأخر عنهم، سلك درباً أطول، أو أخرته صروف الرحلة وحسب.. كان الغريب بين أهله، لا هم يعرفون ولا هو يعرف”.
تسير الرواية الصادرة عن منشورات “المتوسط” في إيطاليا، بخطين متوازيين يلتقيان على عتبات بيت “بطرس النجّار”، يفصل بينهما زمانيّاً قرن ونصف القرن، وتربط بينهما وفاتان الأولى لموسى الشلبي نهاية القرن التاسع عشر، والثانية لريما زوجة الأستاذ الجامعي عماد العايش في العام 2017، والبيت أيضاً، فيما تتسع الفجوة الزمانية مع توالي السرد وعتباته التي لا تعترف بالحسابات الرياضيّة لقرابة القرنين أحياناً.
ولم تنتهِ حكاية “موسى الشلبي” بسقوطه عن بغلٍ، وموته بعد “نوم” طال، فقد جاءت زوجته “نعمة” ابنة “بطرس النجّار”، وبعد حين “انقطع دمها” ثم شعرت بجنينها، إثر قيام زوجها المُحتضِر فجأة ليقع عليها، ومن ثم يدفن في اليوم التالي، ما دفع عائلتها إلى حبسها حتى تضع مولودها “سالم” ويأخذ اسم جدّه، فيصبح أمام الناس شقيقاً لـ”خليل” ابن “النجّار” الأكبر، وهو في واقع الأمر ابن شقيقته، وهي الأخوّة التي تجعل “خليل”، بعد حين، مطلوباً للتجنيد في الجيش السلطاني العثماني، فيُهاجر البلاد إلى أميركا.
كان هذا في رام الله، ولكن حكاية “النجّار” الجدّ تعود إلى البادية الأردنية، حيث كان رفقة شقيقه يصطادان في البريّة، قبل أن يصطدما بجنود أحمد باشا الجزّار، الذين أرادوا سلبهما طريدتهما، وحين تعنّتا قتلوا شقيقه، بينما ربطوه بأحصنتهم وساقوه إلى عكّا، بعد أن فقد القدرة على النطق لهول ما شاهد وعايش .. هناك يحتضنه نجّار لبناني يعمل كما غيره على تلبية رغبات “الجزّار” بإعلاء أسوار عكّا عمّا هي، فيعلمه النجارة، ويحمل لقبها اسماً له، بعد أن يتعذر للآخرين التعرّف على اسمه الفعلي، قبل أن يفرّ بعد سنوات، مع عدد من الهاربين، إلى رام الله القرية حينها، فتطيب له، ويحطّ فيها الرحال.
“بيديه فتح لنفسه طريقاً في القرية، حرفته مطلوبة، وملامحه الحزينة الهادئة بعثت السكينة في نفس كل من رآه.. ولأنه نجّار غريب، جاءهم على حمار هزيل، قادماً من الشمال يقصد ملجأ وحياة، أحبّوه أكثر، لعلّه ذلك الحبّ الغيبيّ للغريب المقهور القادم من الشمال يحمل أمله، مارّاً بقريتهم رام الله في دربه من شمال فلسطين إلى أورشاليم ليتمّ مجده.. أهل القرية الذين فتكوا ويفتكون ببعضهم عند كلّ نزاع، أحبّوا الغريب الذي أتاهم خاوي اليدين إلا من حرفة يحتاجونها من احترفوا الاشتغال بالحجارة والمعادن، كانوا بحاجة لمن يساير الخشب، ويعرف كيف يفعل فيه أشياء شتى غير الحرق والتقطيع (…) سمع وهو يحفّ الخشب في رام الله أنه لولا أسوار عكا، التي قدَّ مع خلق كثيرين حجارتها، لحاز الفرنسيّون هذه البلاد”.
ويرصد الروائي عبر “النجّار” وأبنائه وأحفاده حكايات رام الله وأهلها، وعموم فلسطين، فكان حديث عن معارك عائلاتها، والحجّاج الروس إليها، ومدرسة “الفرندز”، وموجة “الكوليرا”، والزلزال الذي ضربها في العام 1927، منتقلاً ما بين الحقبة العثمانية، والحكم العسكري البريطاني قبل الانتداب الرسمي وبعده، والاقتتال مع اليهود الصهاينة في محطّات عدّة شكّلت “سنوات الهبّات والانتفاضات”، وصولاً إلى الثورة الكبرى في العام 1936، فسنوات “الإرهاب الصهيوني”، ثم الحرب العالمية الثانية بعد أن لم يكن قد أغفل الحرب العالمية الأولى وقبلها تأسيس بلدية رام الله، فانتهاء الانتداب البريطاني تاركاً فلسطين للعصابات الصهيونية وبطشهم في العام 1948، أو ما بات يعرف بـ”النكبة”، ومن ثم فترة تحوّل الكثير من سكان البلاد الأصليين إلى لاجئين خارج فلسطين وداخلها، بما فيها رام الله.
“فتحت رام الله كنائسها، ومن الكنائس فُتحت البيوت، تقاسم الناس بيوتهم.. (هؤلاء إخوتكم في تجربتهم الأقسى، لا ينالهم جوع ولا عطش وهم بيننا)، قال الخوارنة والقساوسة ووجوه رام الله.. حمت كل طائفة أبناءها ونفرت لإيوائهم، كأنّ تشريدهم يجب أن ينتهي في رام الله (…) منذ إبريل ورام الله مقصد الهاربين من الموت وأخباره، المتأمّلين عودة بعد حربٍ سريعة”.
وفي ما قبل النكبة، لم يكن الرصد الروائي كله ذا طابع سياسي، بل استخدم عبّاد يحيى عدسته السردية في التقاط ما يوثق لحيوات أهلها وسكانها اجتماعياً، وثقافياً، واقتصادياً، بل ومعمارياً أيضاً، حيث يسير بالقارئ إلى رام الله التي باتت المدينة الحديثة الأكثر تطوّراً، والأبرز على أكثر من صعيد، بعد أن كانت قرية لها طابعها الخاص قديماً.
ويمرّ السرد على هزيمة العام 1967، واحتلال الضفة الغربية بما فيها رام الله، والأذان الأول في المدينة العام 1969، وانتفاضة الحجارة في العام 1987، ثم قيام السلطة الفلسطينية ودخول أبو عمّار ورفاقه إليها، والتحوّلات التي طالت المدينة إثر ذلك، فاندلاع انتفاضة الأقصى في العام 2000 التي كان للدار حضورها فيها كمأوى للمقاومين، كما حضرت في ثورات وانتفاضات سابقة، الدار وأهلها.
في العام 2017 يرد لعماد العايش، الأستاذ في جامعة بيرزيت، اتصال مفاده أن زوجته الراحلة “ريما” هي واحدة من ورثة عقار في رام الله، من بين كثير من الورثة مات بعضهم، فيبدأ بالتردد على “دار بطرس إبراهيم النجّار بناها خليل بطرس إبراهيم النجّار سنة 1921″، لتبدأ عتباتها بمحاكاته ساردة حكايات سكان البيت منذ تأسيسه، وعبرها حكاية المدينة القرية أو القرية المدينة “رام الله”.
بالنسبة لي، أثارت فيّ الرواية الكثير من الحنين إلى ماضٍ لم أعشه، والكثير من الشجن فيما عايشته يافعة وأكبر إلى يومنا هذا في رام الله .. هي رواية يمكن وصفها بالمرجع، بذل فيها صاحبها جهداً كبيراً لتخرج أنيقة عميقة، مُنسابة بسلاسة رغم تجاوز عدد صفحاتها السبعمائة، وبلغة جاذبة ورزينة تلاحق أحداثاً تتشابك رغم تعدد المراحل الزمانيّة وتنوّع الأماكن، فيما تبقى “رام الله” الحدث والحديث الأول فيها، كما في فلسطين الجديدة التي تخلع فيها القرية ثوبها مرتدية زي المدينة لأكثر من مرّة في مئة وخمسين عاماً، وصولاً إلى ما هي عليه الآن، تماماً كما خلع الكثير من “الثوّار”، ما بعد تأسيس السلطة، زيّهم العسكري مرتدين البذل وربطات العنق، مترجّلين من مركباتهم الفارهة باتجاه مطعم “بلدنا”، الذي قد يكون هو ذاته بيت “بطرس النجّار”.