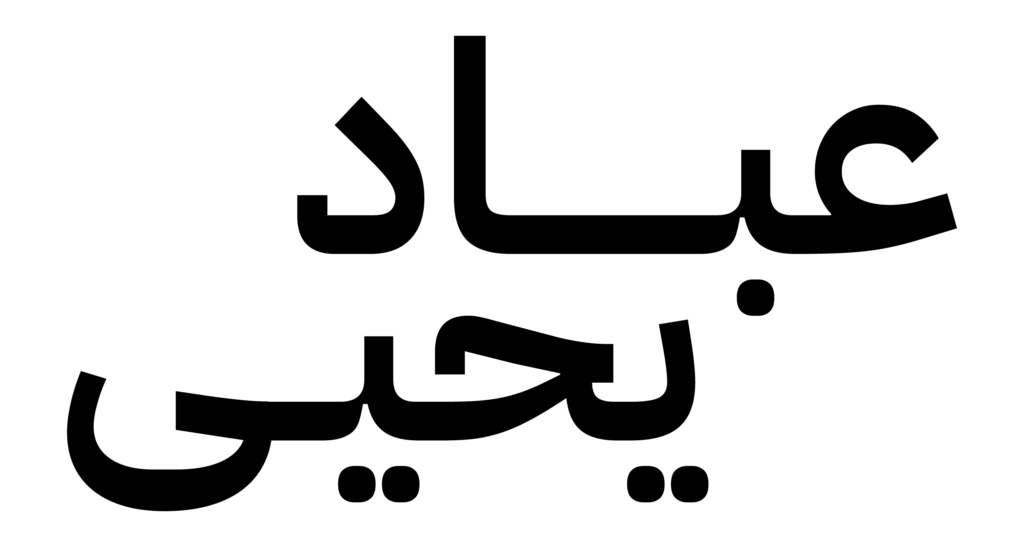لقد درجنا عادة، مطلع كل عمل روائي، أن نجد إهداءً. ولأن «رام الله» رواية الكاتب الفلسطيني عباد يحيى تنوء عن العادي والعادة فهي دونه تزجنا مباشرة منذ أول صفحة فنجد أنفسنا داخلها. يدرج عباد يحيى كاستهلال لعمله، ما سيجعلنا نلهث طيلة 700صفحة لنعرف صحته، إذ يتذكر عماد العايش بعيد وفاة زوجته ما سمعه من أمه بأن الله يتلطف بعاشقين حرما العيش معا فيُميتهما في اليوم نفسه. هذه الفكرة بما تحمله من خبث، ستتحول إلى وساوس حارقة تلتهم كل أوقات الدكتور، حتى أنها ستجعلنا كقراء للعمل نتجرأ على التفكير بأن مجرد الشك بريما هو خيانة لها. ثم حين يتعاظم الصراع الداخلي يتفاقم شعور الإدانة ذاك؛ أي إدانة الدكتور لما يقترفه من تشكيك في حق زوجته لمجرد الأسطورة التي قالتها أمه والصدفة التي جعلت مسلما يدفن في نفس اللحظة التي تدفن فيها زوجته. يتولد لدينا يقين أن ريما لم تخن زوجها، أنها الأسطورة وأن عباد سيحطمها. ثم تصعقنا الحقيقة، حين نكتشف أن ما ظنناه شكا، وما ظنه الدكتور انقيادا لجعل الأسطورة حقيقة؛ هو الحقيقة نفسها: فيتشكل لدينا مفهوم جديد للحدس، أو لصدقه.
وتحت خدر الوساوس يصلنا العمل، عبر سلسلة من الرواة بشرا وجمادا. بشرا على غرار عماد العايش وبطرس النجار وخليل وسالم وهيلانة، وجمادا كالعتبات التي تتكلم مفجوعة من غياب أهلها.
نسمع أن «التاريخ يكتبه المنتصرون» ولأن «رام الله» تحيد عن المألوف فليس مستغربا أن يكتب تاريخها المنهزمون. ففي مدينة من بلاد تلقت هزمات متتالية؛ احتلالا إثر آخر كانت تلقى الهزائم كما الملاكم المحشور في الزاوية. من عثمانيين تركوها منهكة لتواجه بريطانيين متسلحين بالراحة والعتاد ثم إلى إسرائيليين مدعمين بعالم خلف ظهرهم. فأنى لهذه المدينة أن تنجب منتصرا واحدا ليدون تاريخها؟
عبر نسل آل النجار يقص عباد لنا تاريخ المدينة، أو تاريخ البلاد. من حروب وتهجير ودمار ومؤامرات وخيانات، من انتفاضات وتهاون وانكسارات وخسائر، من حب وهجر وفقد وموت، من أديان ومعتقدات وتقاليد راسخة ونبوءات، ومن أراض وأشجار ومواسم حصاد. حتى أننا مع انتهائنا من الرواية يختلط علينا الأمر فلا نعرف أيها كنا نعرفه قبلا وأيها عرفناه من الكتاب، هذا التساؤل يبلغ الدكتور عماد، ذلك أنه ما عاد قادرا على التمييز بين ما عرفه عن رام الله من العتبات وما كان يعرفه أصلا.
لعل قدر رام الله، بل فسطين كلها أنها ما تكاد تتخلص من محتل حتى تفاجأ بآخر. أن شعبها ما يكاد يحفل فرحا بعدو راحل حتى يفاجأ بآخر غاد. أن الحرب التي يهللون لانطفائها ما تلبث أن تعاود الاشتعال تحت لواء محتل جديد. حتى أن سالم يندهش من الأمر فيتساءل: «كيف أشعر حينا أن كل شيء قد تغير، وفي الوقت نفسه أشعر أن لا شيء تغير؟».
ربما أنطق يحيى العتبات ليقول لنا بأن ما تَلَاحق على هذه المدينة/ الدولة من حروب ومجازر وهجمات، من قتل وتنكيل، من هدم وتخريب؛ كل هذا الأسى إن جعل إنسانا يفرغه بحكيه فهو المألوف، لكن وفي رواية اللامألوف ستنطق العتبات، سينطقها الوجع.
لكن الرواية مليئة أيضا بالحب، كما الحياة. «هل يمكن فهم المدينة دون الحب؟ دون ما يمنحها عمقها، ويحولها من خريطة إلى حقيقة؟». إلا أنه حب ناقص دوما، وفي عرفه «ثمة ضحية بعد حب عارم لم يكتمل بدوام عيش المحبين معا: أحد الحبيبين». فنلحظ من تتبع قصص الحب في الرواية أنها مبتورة، أحدهم تظل حبيبة صغره مجرد حلم بعيد، وآخر يرفضها بعد أن جاءته ركضا لقبول عرض زواجه، ثم لدينا من يرجئ حبها الخوف من رد فعل زوجها، من يموت حب حياتها على سرير المرض فتموت هي بعد سنوات طوال حين يَعْلق بحبها رجل آخر على سرير المرض قبل أن ينال منها قبلة… الحب دوما مبتور وكأن يحيى يقول لنا أن قصص الحب المكتملة لا توجد في الواقع ولا الروايات.
ثم هي رواية النبوءة، الأسطورة التي تجعل عماد العايش يركض خلف الحقيقة لتكذيبها، فإذا ما توصل إلى الحقيقة صدق بها أكثر. يقول: «تكذيب الأسطورة أوصله للحقيقة، والحقيقة أوصلته لتصديق الأسطورة». نلمس في العمل أيضا اجتهادا في نقل الثقافة السائدة خلال كل فترة، سواء تعلق الأمر بالغذاء أو العمران أو حتى الهيئة؛ نرى تبدل هيئات الناس تزامنا مع تغير المحتلين، ونجد التمييز العنصري المبني على أسس دينية. فالعسكر يتخيرون من يسوقونه للتجنيد. والتجنيد أو الأخذ عسكر كما عرف وقتها لم يكن إلا موتا محتما لمن سيق له. لذلك ربما «انشدهت هيلانة… كأن ما جاء به بطرس هو خبر موت خليل لا طلبه المرقوب للحاق بالعسكر العثماني». حتى اللهجة، نشهدها تتغير، كما لو أنها تجاري العصر، تركض خلفه، فلا تتركه يبتعد عنها. تركض لتجاري أسماء الحرب المغلفة «وجود وانتداب وحماية واحتلال وأخيرا كيان صهيوني». ثم الهجرة التي تحولت من كلمة مرهبة، تحيط بكل من يفكر فيها هالة من الخوف عليه والتخوف منه، إلى كلمة ممضوغة صارت مآلا للجميع، حتى ما عاد الناس يسألون عن دوافع كل من يفكر فيها. يقول الراوي: «وتوقف أهل رام الله عن السؤال عن أسباب الهجرة، صار الأمر عاديا لا يستدعي سؤالا، ثم صار قدرا واضحاً». الرواية تذكرنا بالفوضى التي تحدثها الحروب، فبعض العائلات تُهَجّر وبعضها الآخر يرحل قبل أن يطردوه، البيوت يُستولى عليها، عمال يطردون وآخرون ينالون مناصب في الدولة الجديدة، محكومون يخلى سبيلهم وآخرون يتم القبض عليهم. لكن رام الله تحافظ على نفسها، حتى تصير ملجأ للوافدين من يافا والقدس، ومن اللد وحيفا وغيرها. وفي ظل التمنع الذي تبديه رام الله يكثر راغبوها؛ فمتى ما وجد التمنع والصد وجدت الرغبة. لكن الرغبة لوحدها لا تكفي، ذلك أن وقود كل رغبة في احتلال أرض هو انبطاح أهلها، ومتى ما رفعوا أيديهم معلنين استسلامهم تجد المدينة وقد سلمت نفسها لغاصبها الجديد. «هذه البلاد المتقلبة من حكم إلى حكم، وحال إلى حال، ينتهز فيها الناس الأوقات البينية بين عهد وآخر، يثبتون وقائع كما ثُبتت عليهم».
وتلك الدار، التي بدأت من تصدع في جدار إلى مطعم رفيع لا يرتاده إلا كبار مسؤولي الدولة، ألم تمت؟ لعلها ظلت حية دائما، تتجدد دائما دون أن تتبدد لكنها وفي اللحظة التي تموت فيها هيلانة صاحبتها تفقد ألقها، فيبدو السور الذي يبنيه سالم حولها ليكفها عن أعين اللصوص كما الشاهد الذي يزين قبر صاحبتها. ذلك أن الدار ماتت مع هيلانة، ألا تموت الدور مع موت أقدم ساكنيها؟
حين تنتهي من قراءة «رام الله»، أنت لن تكون نفسك. ستكون عماد العايش واقفا مذهولا ومتسائلا: أيّ ما يدور برأسي الآن أعرفه قبلا وأيّه عرفته من الرواية. أنت ستمتلئ بفلسطين؛ برام الله وحيفا والقدس، بعكا وغزة ويافا واللد، بالخليل والرملة وبئر السبع، عقلك سيتفجر بما ورد فيها من شخصيات وقصص من تاريخها الحافل. ولكن رغم حجمها الكبير، رغم الفترة الزمنية الطويلة التي تغطيها، رغم الشخوص الكثر، رغم جزالة الوصف، رغم الحروب، رغم حكايات الحب العديدة الخائبة، رغم ملايين المهاجرين، رغم مئات الشهداء الذي يزفون كل يوم للدفن؛ إلا أنها ليست سوى سيرة مختصرة؛ مختصرة جدا من الوجع الفلسطيني.
ومع ذلك فإن يحيى لا يكتبها باكيا أطلاله، وإنما يكتب الرواية كما ينبغي لها أن تكتب. بحبكة محكمة، وسرد آسر، بشخوص حقيقيين تتملكهم العقد والمخاوف، وتستحوذ عليهم الآمال، تسري بهم الأفكار المتناقضة. شخصيات بها كل ما يسم كائنا بالإنسانية. وبتأثيث يصعب خلقه روائيا؛ كل ذلك ليضعنا أمام الصورة. ومن خلال جهده في هذا العمل نراه أحيانا مؤرخا، وفي أحيان أخرى فنانا، نراه عالما، ونراه رجل دين، نراه عاشقا، ونتوصل في الأخير أنه متيم بالجمال؛ ولا يصدر عن متيمه إلا عمل جميل ومتقن، كهذا العمل.
يرى ماركيز بأن «الكتب الجيدة تصبح أقل يوما بعد يوم» وقد كدت يوما أن أقول بأنها لم تعد موجودة أساسا، كان ذلك قبل أن أقرأ رام الله، الرواية الجيدة التي نقرأ كتبا عديدة لنجدها. إنها بالتأكيد نصر إضافي لفن الرواية الذي يموت مضمونا، رغم أننا نراه يتكاثر شكلا على أغلفة الكتب. وهي إضافة إلى كل ذلك العمل الذي سيجبرنا على قراءته مرات ومرات، كلما استبد بنا الشعور الزاعم بأن الروايات الجيدة غير موجودة. سنقرؤها لنعيد إحياء ذوقنا الفني، لنعيد تذوق الرواية.
عباد يحيى: «رام الله»
منشورات المتوسط، ميلانو 2020
736 صفحة.